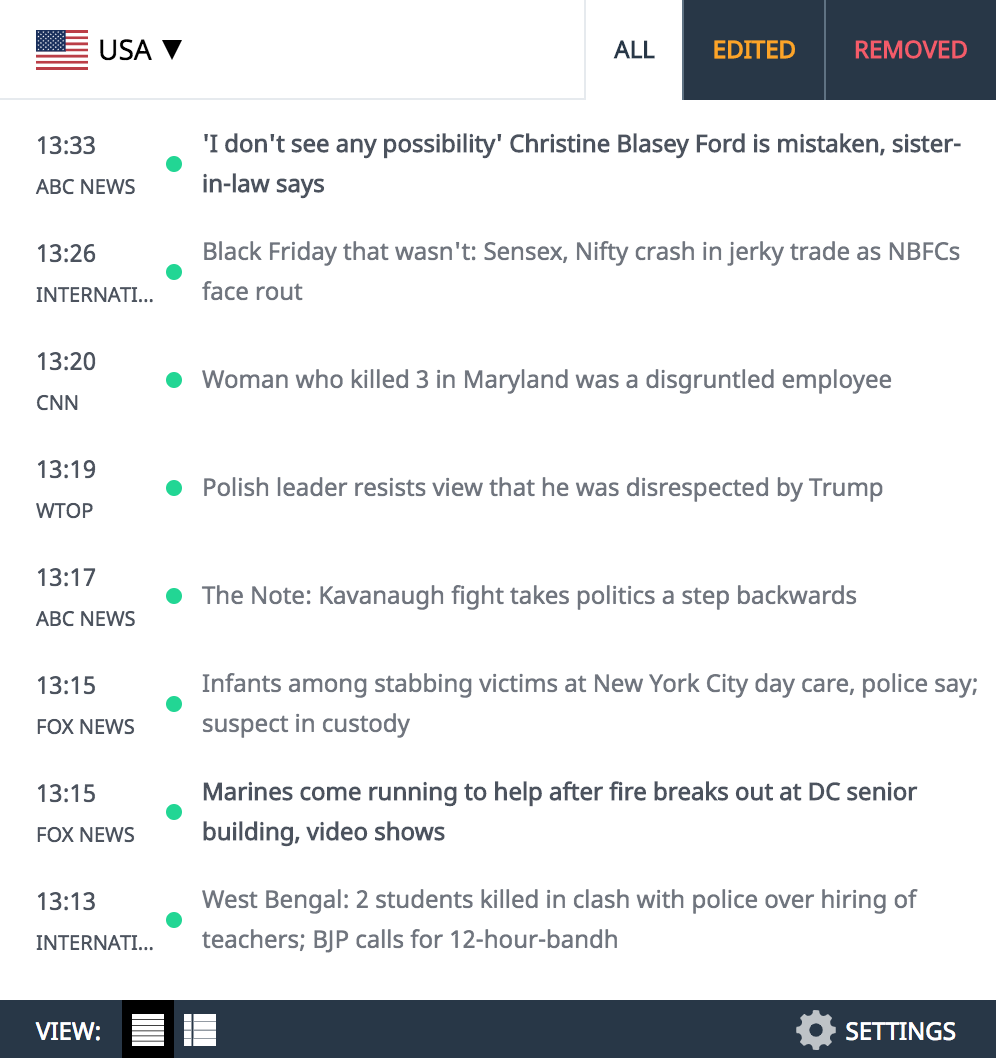من جدّة إلى بكين.. هل تحقق الصين ما لم يفعله العرب؟
في حمأة الأحداث والتطورات الدّولية العالميّة التي تتجه وفق المقروء منها نحو تثبيت انزياحاتها في الصورة الجديدة للعالم قيد التشكّل، الذي يسير في مناوئة الأحادية القطبيّة إلى ترسيخ قوّة اقتصادية أثبتت تفوّقها في بعض المحطّات على الإرهاب الاقتصادي الأميركي كنتيجةٍ حتمية لهيمنة القطب الواحد بثقافته وأساليبه.
تأتي زيارة الرئيس السوري بشار الأسد للصين في ظلّ هذه المتغيّرات، وتنبسط قراءة المشهدية بمفرداتها الحالية بعنوانين رئيسين، الأول هو نوعيّة الاتفاق المنعقد بين الصين وسوريا، والثاني هو طبيعة النظرة الصينية للحالة السّورية في الصراع الدوليّ؛ حيث لا تزال سوريا ساحةً لتناحر عدّة فواعل دوليّة تتباين رؤاها بشأن حل المسألة السورية التي تتلظّى حتى اللحظة بالاحتلالين الأميركي والتركي ومفاعيل الحصار بعنوانه العريض مع ما يرافقه من ترهّل اقتصادي – إداري ملحوظ كنتيجة شبه حتمية له.
في العنوان الأول، يجب أن نتروّى في دراسة مفاعيل اتفاق التعاون بين البلدين، ففي الاتفاقات التي تعقدها الصين هناك تدرّج في نوعيتها، وهو ما يؤسس بالضرورة لتفاوت في طبيعة التعاون ومدى تأثيره بالدرجة الأولى على عدة صعد وفي مقدمتها الاقتصادية، وتتأتى النوعية أيضاً من موقعية الطرف الموقّع ووزنه السياسيّ والاقتصاديّ في مقابل أكبر قوة اقتصادية في العالم أي الصين، ففي مشروح مفردة الاتفاق الصيني – السوري الأخير برز التوصيف على لسان الرئيس الصيني “شي جين بينغ” بأنها شراكة استراتيجية ما يعني التنسيق الوثيق والدقيق في مجال العلاقات الإقليمية والدولية، التي تمهّد بدورها إلى لعب الصين دور أكثر اتضاحاً في تعزيز الدور السياسيّ السوري في النسيج الدولي، ولا سيما في خطوة قبول سورية كشريك حوار (قبل العضوية الكاملة) لمنظمة “شنغهاي” التي رسمت دورها منذ تأسيسها عام 2001 كثقل جيوسياسي موازن للولايات المتحدة الأمريكية.
في العنوان الثاني، يقف حائلاً في وجه التنمية السورية بمساعٍ صينية تنظر للتنمية الاقتصادية كجزء من التنمية البشرية، حالة الملفات العالقة لإنهاء الحرب على سوريا وفيها، فلا تنمية بدون استقرار من وجهة النظر الصينية، ولا استقرار بدون حل سياسي ودبلوماسي سوري يمكن للصين التي أحدثت خرقاً في التوتر السعودي – الإيراني، الذي توضّحت ملامحه عشية الحرب على سوريا من تسعير عربي داعم لعزلها وتدميرها، هذا الخرق الذي تجلّى في أهم اتفاق على مستوى منطقة الشرق الأوسط بين السعودية وإيران، أن تلعب دوراً هاماً في التوصّل لحلّ سياسيّ ولا سيما مع الجانب التركي الذي بات يتململ نسبياً من حليفه الأوروبي لعدة اعتبارات ومنها الاقتصادية، ففي هذا الحلّ ضمان لمبادرة “الحزام والطريق” التي عُدّت سوريا شريكاً فيها بُعيد القمّة.
تاريخياً، قام الفينيقيون منذ الألف الثالثة ق.م بتحويل البحر الأبيض المتوسط لبحيرة فينيقية، لمدة تجاوزت الألف عام، واستطاعوا الربط ما بين غرب أوروبا والشمال الإفريقي وغرب آسيا، لذا كانت هذه المنطقة عبر التاريخ منطقة الصراع بين القوى العظمى التي كانت تريد تأكيد هيمنتها وسيطرتها بالتحكم بطرق المواصلات وضمها لنفوذها حتى تستولي على طرق التجارة البحرية والبرية العالمية، وبانسحاب تاريخي يظهر لنا طبيعة المنطقة التي أهّلتها لصراعات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، ليكن التنافس الاقتصادي بيضة قبان التوازن الدولي متعدد الأقطاب ومتنوّع الشراكات، ويبرز اليوم التنافس الأميركي – الهندي، مع الصين صاحبة مشروع “حزام واحد طريق واحد”، في مسألة الممر الاقتصادي عبر ميناء حيفا بما فيه من تعزيز لعلاقات “إسرائيل” والهند المتنامية بإطراد، في مقابل حضور سعودي مستفيد بكافة الأحوال عبر الدمج مع مشروع “نيوم 2030”.
يُنظر للزيارة من الموقع الجيوسياسي لسوريا، كصلة وصل بين الشرق والغرب، الذي يشكل مفتاح الحرب القائمة حالياً بين معسكرين الأول بقيادة الصين وروسيا وإيران، والثاني بقيادة أميركا والغرب الأوروبي وبعض القافزين من الثاني للأول، فالجغرافية أساس للاقتصاد الذي يشكل عنوان المصارعات القائمة بضجيج خفيض نحو التشابك الاقتصادي المحقق للاستقرار السياسي، فعلى سبيل المثال أصبحت الصين منذ عام 2022 الشريك التجاري الأوّل لإيران متقدمة من رقم 50 قبل عامٍ فقط، وبلغت الصادرات النفطية الإيرانية في آب الفائت 1.5 مليون برميل يومياً، وارتفاع التبادل التجاري بين الصين وروسيا لـ 40 % في عام 2023 مقابل انخفاضه لـ 15 % مع أمريكا.
تتميز السياسة الصينية بالقدرة على التوفيق في التقاطع ما بين المصلحة والإيدولوجيا، مع الحفاظ على التعاطي السلميّ مع مجمل التطورات الدولية العالمية ومنها العربية، ويتجلّى ذلك من خلال دعمها للمبادرات السلمية الحوارية بين الأطراف المتنازعة وهذا على خلاف مكمن عمل سياسة الولايات المتحدة الأميركية التي تُحارب كل الدول الغير متجاوبة مع سياساتها الخادمة للجماعات الضاغطة في مراكز صنع القرار الأميركي وهذا ما يدخل ضمن اللاهوت السياسيّ لها والعقيدة الناظمة لعملها، وهو ما يندرج ضمن استراتيجيتها: “أمريكا أولاً”.
اتسمت مرحلة ما قبل العودة لجامعة الدول العربية بحركة سياسية داعمة، لتصطدم بعدها بمقدمات بُنيت عليها حركة الدعم بمطالب أميركية – عربية لا تتفق ورؤية دمشق لها، وما بين جدّة وبكين نظرة استراتيجية من الرؤية السورية، والتي أرى بتقديري التعويل على مكتسبات فرصة التموضع الدولي الجديد، قال سابقاً الرئيس الأسد خلال القمة العربية الأخيرة في جدة: “نحن اليوم أمام فرصة تبدّل الوضع الدولي الذي يتبدّى بعالم متعدّد الأقطاب كنتيجة لهيمنة الغرب المجرد من المبادئ والأخلاق والأصدقاء والشركاء، هي فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بأقلّ قدر من التدخل الأجنبي، وهو ما يتطلب إعادة تموضعنا في هذا العالم الذي يتكون اليوم كي نكون جزءاً فاعلاً فيه”. وفي بكين: “زيارة مهمة في التوقيت والظروف.. حيث يتشكل عالم متعدد الأقطاب يعيد له الاستقرار والتوازن”.
فما بين القمّتين توجّه سوري واضح، فما بين عرقلة عربيّة، وتطلّع صينيّ لمستقبل أكثر إشراقاً لسوريا في هذا النظام الجديد هل تحقق الصين ما لم يحققه العرب من حلّ شامل يكون عنوان مرحلة جديدة في الصراع الصيني – الأميركي، أو استكمالاً له في ساحاتٍ متعددة؟
يمكن القول، أن الصين باتت تتطلّع لدورٍ أكثر فاعلية عبر دبلوماسيتها الرزينة إلى قيادة دور عالميّ قائم على استراتيجيات التعاون والتشارك المتبادل، ويظهر هنا الدور الأمريكي المعطّل لذلك وأبرز مشهد في العراق عبر الضغوط لمنع الاستفادة والتأسيس للاستفادة من مشروع الصين التي تبلغ وارادتها النفطية 10 % من العراق، وتأتي أهمية هذا الدور في الرغبة للخروج من تبعات الهيمنة الأمريكية بأقل قدر عبر إشغال شغور مقاعدها في الشرق الأوسط وسبر ملمح الحرب الدبلوماسية معها صينياً.
المصدر: بريد الموقع